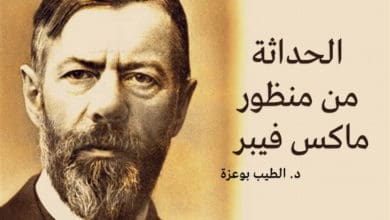هل حقا هناك مشروع إسلامي؟

(1)
الأمة الإسلامية عبر تاريخها وفي بعض منحنيات تدافعها وصلت إلى درجات شديدة التردي من الهزيمة والضعف، فاقتتل يوما خيرة أصحاب نبيها، وتحول الأقصى يومًا فصار حظيرة خنازير، حتى البيت الحرام تم غزوه واختُطف الحجر الأسود ثم كانت النكبة الأعظم والأشد أثرًا في تاريخنا وهي الغزو المغولي الذي خُتم باستباحة بغداد وقتل مئات الآلاف في يوم واحد.
لكنها في كل هذه المنحنيات لم تكن قط في حالة ضعف عام وافتقاد شامل للشوكة وفقدان للرؤوس المؤهلة من القادة والسادة والفقهاء وجهل العامة وتفككهم كما هي اليوم.
عبر تاريخنا تسقط الأندلس لكن سقوطها كان في نفس القرن الذي كان فيه فتح القسطنطينية، يرفل في الترف والدعة والضعف والقعود خليفة بغداد العربي القرشي، فيأتي النصر على يد الأكراد والأتراك، وتسقط بغداد وتهزم الشام فتنتصر مصر، وتضعف السلطة فيقوى المجتمع.
لكن أن يشملنا الضعف هكذا، هذا لا عهد لأمتنا به، إلا في المائتي عام الأخيرة، والتي يؤرخ بها عادة لأفول قوة العالم الإسلامي وسقوطه بين قطبي رحى: سلطات لا تمثل قيمه، ومجتمع متفكك لا يملك قوة يستعيد بها مجده، نخر السوس الغربي في أعمدة ثقافته وقيمه، مع شيوع حالة عامة من التشرذم والتفكك والضعف المادي والمعنوي.
في هذه الظروف القاحلة، وعبر مائة عام تقريبًا طرحت الحركات والتيارات الإسلامية نفسها كحامل وسيط لمفاتيح علاج هذه الأدواء، من أجل العودة بالأمة إلى سابق عهدها، وتم تأطير هذا بمصطلح يُستعمل في سياقات استعمال مصطلحات النهضة والتقدم على أنه هو الحل، أعني مصطلح: المشروع الإسلامي.
(2)
المقصود بالمشروع الإسلامي في هذه السياقات هو الرؤية القيمية والثقافية والتقنية والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المستندة للوحي والشريعة والتراث، والقادرة على إقامة الدين في الناس والنجاح في تدبير أمور الدول، وتحقيق القدر الضروري من العدالة والأمن وكفاية حاجات مجتمعاتها، وتحقيق حد أدنى من الغلبة وامتلاك القوة المؤهلة للردع والنصر.
ولدينا هنا على هذا التصور نقاش يمكن تركيزه في ثلاثة أسئلة أساسية:
(1) هل يمكن تقديم هذه الرؤية؟
الجواب: نعم يمكن تقديم رؤية في هذه المجالات تستند إلى هذه الأسس؛ فإن هذه الأسس قد استطاعت بالفعل من قبل أن تكون أساسًا لأمة قوية عبر تاريخ طويل ممتد تعد به من أكثر الأمم التي امتدت تجليات قوتها زمنيًا.
(2) هل يمكن تقديمها وتكون ناجحة ومتفوقة بالفعل؟
الجواب: نعم يمكن تقديمها وتكون ناجحة ومتقدمة بالفعل، لكن هذا النجاح لا يمكن حدوثه بمجرد الاستناد للأسس المذكورة، وهذه الفكرة هي أحد أهم جوانب الخلل في كل التصورات السائدة عن المشروع الإسلامي أو عن كون الإسلام هو الحل.
“إن شهوة طرح المشاريع الشاملة وادعاء اكتمالها نظرًا وعملًا هو إحدى أهم إشكاليات التيارات الإسلامية، وندعو لطرح بدائل بناءة تقنع بكونها جزئية، وتقر بحاجتها دائمًا للوصل مع غيرها من البدائل المناظرة لها، وتعترف بافتقارها المتصل لاختبار تصوراتها النظرية، وترشيد تجاربها العملية” أحمد سالم
نريد هنا أن نميز بين أمرين يقع بينهما الخلط، فصحيح أن الوحي تبيان لكل شيء، وفيه هدى ونور، ولكن مجرد الاستناد لذلك دون عمل علمي يأخذ بأسباب تجويد النظر وتسديد العمل غير مجد.
فلا يمكن حل المعضلات المعاصرة بمجرد الاقتباس من نصوص الوحي أو التراث، دون تفعيل ذلك بجهد بحثي جاد، بأدوات المعرفة الصحيحة، والملائمة للمجالات المعرفية المختلفة.
فضلًا عن أن نفس الفهم لشمولية الوحي لا يستلزم النص، أو حتى الدلالة الواضحة على كل أمر من أمور الدين والدنيا، فإن الاجتهاد الدنيوي، في كثير من المسائل الثقافيَّة والسياسيَّة والاجتماعية والاقتصاديَّة قد وكلها الوحي لاجتهاد الناس فيما هو أصلح لهم، ووضع الأطر القيمية العامة لذلك، ونص أو دل على بعض المحكمات في بعضها.
فتصور الإسلامي الذي يكتب رسالة فيها بعض محكمات الشريعة وأسسها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ مع شذرات نقدية يتصور أنه يهدم بها الأسس الفلسفية للعلمانية، أو الحداثة، أو الشيوعية، تصوره أنه بذلك قدم مشروعًا إسلاميًا، دون اشتغال معرفي موائم لتلك المجالات هو مجرد وهم، مجاف للحقيقة للأسف، وهذا بالإضافة لما يقع من أخطاء حتى في تصوراتهم للمحكمات الشرعية في هذه المجالات.
نعم يمكن أن يصدر الفقيه فتوى بشأن نظام ما، بشرط أن يكون على اطلاع تام عليه، يبين تعارضه مع محكمات الوحي. وهذا القدر لا يمكن الاعتراض عليه إلا من منظور علماني يرى عزل الوحي عن واقع الناس.
ولكن البحث هنا فيما يُطلب من طرح الحلول البديلة، والرؤى الكاملة السياسيَّة أو الثقافيَّة أو الاجتماعية أو الاقتصاديَّة لموضوع ما، بما يستلزم البحث العلمي فيه، الذي نُقِرُّ أنه ينبغي أن يكون مأطورًا بالوحي، قيمًا وأحكامًا، ولكن مع ضرورة بذل الجهد المعرفي المناسب والملائم لذلك العمل.
ومع ما تقدم، فلا بد من اليقين التام بأن الاستناد لمرجعية الوحي لن يُخرج المنتج عن كونه منتجًا بشريًا سيكون فيه من قصور البشر ونقصهم، ولن يكتسب المنتج عصمة لكونه مرتكزًا على الوحي. وفي ضوء تلك المحددات التي ذكرناها نعلم الضحالة التي يعانيها ذلك الطرح في مفرداته التي يتعاطى بها مع أزمة الضعف والهزيمة، وأن الإسلاميين بحاجة ماسة لمزيد من التجويد في الآلات المعرفية، والإنتاج العلمي، بعيدًا عن شعارات مثل المشروع الإسلامي فيها من الأمنية أكثر مما فيها من الواقع.
(3) هل يمكن تقديم مشروع بهذه الصورة بناء على البحث النظري فحسب؟
الجواب: إن الرؤى الإصلاحية والمشاريع الفاعلة في تحصيل قوة الأمم المادية والمعنوية لا يمكن تقديمها أو الوصول لها من غير علاقة جدلية بين النظر والعمل، تقترح وتختبر ثم تعود فتنقح وتقترح وتختبر وهكذا، ولا يمكن تقديم رؤية تامة قادرة على النجاح والاستمرار إلا في أفق ومناخ يتفاعل فيه النظر مع العمل.
ونقر هنا بأن هذا الأفق للوصل بين النظر والعمل تعاني المشاريع الإسلامية من فقد مساحات مشروعة له، في ظل تضييق من حكوماتها، وتعسف وإرهاب من قوى النظام العالمي.
لكن النقد الذي نوجهه للإسلاميين: هو أنهم لا يعترفون بنقص مشاريعهم لافتقادها هذا المقوم المهم من مقومات صلاحية مشاريع نهضة الأمم وقوتها، بل ربما غابت عن كثير منهم ضرورة هذه العلاقة بين الطرح النظري واختباره بالتجارب.
(3)
إن ما أحاول طرحه هنا يمكن تركيز بيانه في أمرين اثنين:
الأول: لا يمكن إعطاء الصلاحية للرؤى النظرية المطروحة من قبل الإسلاميين لمجرد كونها تستند إلى شعارات المشروع الإسلامي أو إن الإسلام هو الحل، ونحن نقدم نقاشنا هاهنا من وجهة نظر إسلامية تؤمن تماما بقدسية المرجعية الإسلامية، ووجوب التزامها في تأطير الفعل الإنساني على اختلاف مجالات هذا الفعل واختلاف مساحات تقييد الشرع لها، لكننا نقول: إن هناك عملًا طويلًا يجب أن يقدم فوق مستوى الشعارات.
عمل يتعلق بدوام مراجعة وتصحيح التصورات النظرية، وامتزاج الخبرات والكفاءات الدينية والدنيوية فيها.
وعمل يتعلق بوجود فرص للوصل بين هذه التصورات وتفعيلها في واقع الناس ثم العودة إلى التصورات وإصلاحها بناء على ما يظهر من إشكاليات تطبيقية في الواقع.
أما النظر إلى هذه التصورات باعتبارها مكتملة الصحة، وباعتبارها مكتملة الصلاحية للتطبيق لمجرد استنادها للمرجعية الإسلامية، فهذا خلل عظيم منبعه الخلط بين مساحة المرجعية النظرية وباقي مساحات النظر والعمل التي هي فهم إنساني وفعل إنساني يقبل دائمًا التخطئة والمراجعة.
الثاني: إن سؤال ما البديل الذي يتم دائمًا به جبه المحاولات النقدية التي يتم توجيهها للتيارات الإسلامية، هو سؤال يفترض صلاحية المشاريع الإسلامية المطروحة للاستمرار طالما لا يوجد بديل في نفس درجة بنائها.
والحقيقة التي أردتُ التمهيد لها بهذا المقال: إن المشاريع الإسلامية المطروحة كلها فيها من نقص النظر وخلل العمل ما لا يجعلها صالحة لإقرار الاستمرار بهذه الصورة، قد تستمر بالقصور الذاتي وقدرتها على استجلاب الأتباع، وهذا لا يد لنا فيه.
لكن الذي يجب علينا هو ألا نقر استمرارها على هذه الحال، وألا نقعد أبدا عن المطالبة بدوام مناقشة تصوراتها النظرية وتجاربها العملية، وألا يستفزنا ابتزاز (ما البديل؟) لأنه في نظري ابتزاز غير رشيد؛ لأنه يفترض أولًا صلاحية لهذه المشاريع بدرجة لا نقر وجودها أصلا، ويفترض سقوطا لهذه التيارات وغيابًا لها، يهول هو في مفاسده التي لا ننكر نحن بعضها بلا تهويل بل ننبه دائمًا على خطورته، لكننا نقول: إن هذا الغياب والفناء لن يحدث؛ فهي مهما انحسرت وأفل امتداد شعاعها موجودة ولن تفنى أصلا لنخشى مفاسد غياب بديل يساويها.
ولذلك فالسعي لبيان خلل هذه التيارات ومشاريعها نصيحة واجبة، وبيانها ينبغي أن يبقى متصلًا. كما أن هذا الابتزاز في الحقيقة يدعوك لتكرار الخطأ الكارثي: هو أن تزعم أنت أنك تملك بديلًا شاملًا مكتمل النظر والعمل، وهذا ما نقول إنه فساد. إن شهوة طرح المشاريع الشاملة وادعاء اكتمالها نظرًا وعملًا هو إحدى أهم إشكاليات التيارات الإسلامية، وندعو لطرح بدائل بناءة تقنع بكونها جزئية، وتقر بحاجتها دائمًا للوصل مع غيرها من البدائل المناظرة لها، وتعترف بافتقارها المتصل لاختبار تصوراتها النظرية، وترشيد تجاربها العملية.